فلسفة التصميم الذكي: النشأة والتحديات
في طيّات تحليل "فلسفة التصميم الذكي"، تتداخل فلسفة العلم مع فلسفة الدين، حيث تتبدّى أسئلة كبرى تُطِلّ برأسها من دون إجابة نهائية.
-
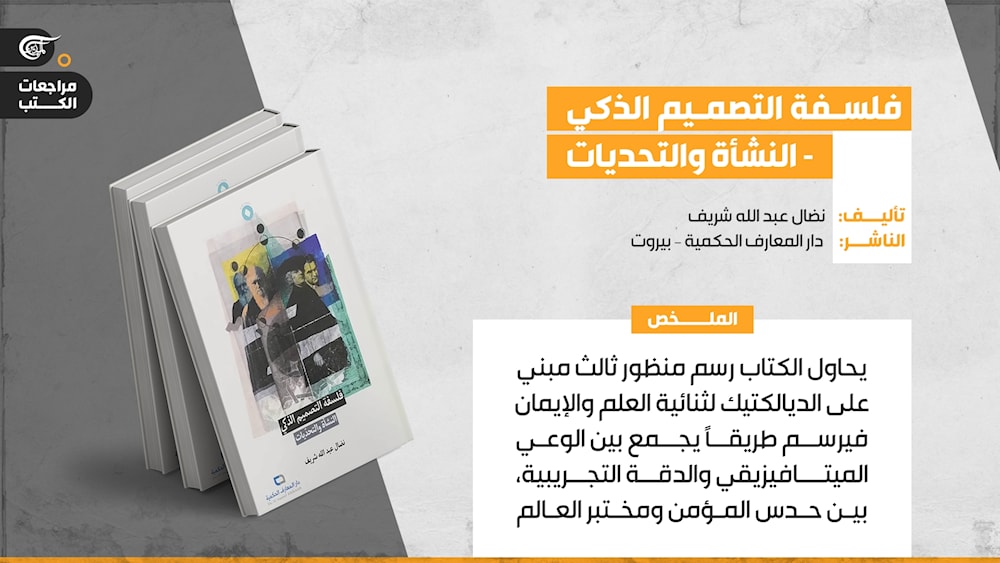
"فلسفة التصميم الذكي – النشأة والتحديات" لنضال شريف
على مفترق بين الإيمان والتجربة، حيث يتلاقى الروحي مع المادي، فتشكل أسئلة ميتافيزيقية تجيب عنها علوم الطبيعة، تتربع أطروحة " التصميم الذكي" لا كخطاب لاهوتي مبني على تسليم إيماني، بل كرسالة عقل تلمس نظامًا كونيًّا صامتًا، يشير إلى قوة غيبية وعقل مدبر لا يقبل المصادفة.
الكتاب ليس أيديولوجيا مموّهة، ولا دفاعًا عصبيًّا، بل معالجة فلسفية تستمد أدلتها من علوم العصر، لا لتأكيد مسلماتها، بل لتفكيك الادّعاءات العلمية بالاكتفاء الذاتي في تفسير التعقيد الكوني.
يبدأ الكاتب رحلة تاريخية فلسفية مع خطوات العقل الأولى منذ فجر التاريخ حيث انسلخ التحليل عن الأسطورة من عمق سؤال إنطولوجي أول:
من أين هذا النظام الكوني؟ وكيف لهذا الضبط الدقيق أن يسيطر على الموجودات؟ فهل للكون منظم يهدف إلى غاية ويُسيّر الكون بعناية رجح احتمالات الوجود فيه على العدمية.
وهنا تبرز إشكالية الكتاب التي أرّقت الفكر البشري:
هل المصادفة العمياء وراء ولادة الكون؟ أم إن نظامًا كونيًّا يدبره وجود غيبي يهدف إلى قصد خفي تعبر عن وجوده إبداعات صارخة في طيات المادة الصامتة؟
رسم الكاتب خريطة فكرية لموضوع الكتاب تتبع من خلالها تطور الإجابات التي قدمها الفكر الإنساني على هذه الإشكالية في مختلف العصور، فبدأ مع "طاليس المالطي" و"هرقليطس" و"أناكساغوراس" وغيرهم من فلاسفة اليونان الذين سبقوا "سقراط"، حيث تشكّلت إرهاصات فكرة العقل المُنظّم، مرورًا بـ"أفلاطون" الذي بلور تلك الفكرة، وعرضها بقواعد متينة. وفي الفلسفات الوسيطة، برهن الفلاسفة المسلمون أمثال "ابن سينا" و"ابن رشد" على إبداعات المنظم بحدود رسمتها الرؤية الإسلامية، وأشار إليها القرآن الكريم. وفي الفكر المسيحي الوسيط، قدّم كلٌّ من القدّيسيَن "يوحنا الدمشقي" و"توما الأكويني" إبداعاتهما التي طورت من الاستدلال.
وبعدها، عرج الكاتب على أفكار فلاسفة الغرب الحديثين ونظرتهم إلى السببية، وصولًا إلى كلٍّ من "هيوم" و"كانط" والتي هزت أفكارهم أركان السببية، وشكّكت في وجودها من خلال نقد إبستمولوجي حديث، لينهي الفصل الأول بتبنّي بعض العلوم المعاصرة لمبدأ الاحتمالات على حساب السببية.
لم يكتف الكتاب بعرض تاريخي لبرهان النظم، بل تجاوزه إلى استعراض معاصر أعاد تشكيل هذا البرهان بصيغته المعاصرة، والتي ظهرت في المجتمع الأميركي حركة تجمع بين المعتقدات الدينية والتطور العلمي، لتستدل من خلال التعقيد غير القابل للاختزال، وبعض الإشارات المتضمنة في الشيفرة الوراثية على خوارزميات رياضية لها مصاديق فيزيائية تقلل من احتمالية العبث وتبطل الحتمية.
يحاول الكتاب رسم منظور ثالث مبني على الديالكتيك لثنائية العلم والإيمان فيرسم طريقًا يجمع بين الوعي الميتافيزيقي والدقة التجريبية، بين حدس المؤمن ومختبر العالم، ليخلق منطقة بين تأمل العقل وتحليل الحواس. لذلك، فهو لا يقدم عقيدة إيمانية جديدة، بل يضع نموذجًا تفسيريًّا، لا يعيدنا إلى الماضي بل ينقلنا إلى مستقبل تتجاوز فيه العقيدة الفلسفية جفاف المادة.
يضع المؤلف ثلاثة إشكالات لدعم أطروحته، ويحاول معالجتها من أبعاد مختلفة.
البعد الإنطولوجي: كيف يفسّر التصميم نشأة الكون؟
البعد البيولوجي: هل يشكّل التطور الموجه ضربة قاصمة للتطور العشوائي؟
البعد الإبستمولوجي: هل التصميم الذكي نظرية علمية؟ أم إنا مجرّد "لاهوت مموّه" كما يتّهمه النقاد؟
ولا يغفل الكاتب عن العمل على رد الاتهامات التي وجّهت إلى مؤيدي التصميم الذكي، إذ يعرض نقد "ريتشارد دوكنز" و"دانييل دينيت" وغيرهما، ويبيّن أن ادعاء معارضي التصميم لا يستند في كثير من الأحيان إلى اعتبارات علمية، بل إلى مبان فلسفية ترفض الاعتراف بوجود يتجاوز المادة.
يتميز الكتاب بلغته الهادئة، وقدرته على التوفيق بين النقل والعقل، بين العرض والنقد. إنه ليس كتابًا تبشيريًّا، ولا يسقط في النزعة الدفاعية، بل يقدّم التصميم الذكي أطروحةً جديرةً بالتأمل.
وفي طيّات التحليل، تتداخل فلسفة العلم مع فلسفة الدين، حيث تتبدّى أسئلة كبرى تُطِلّ برأسها من دون إجابة نهائية:
ما حدود المنهج العلمي؟ وهل يستطيع أن ينفي ما لا يستطيع إثباته؟
وهل هناك جانب ميتافيزيقي في النظرية العلمية؟
يتجاوز النص الدراسة الفلسفية ويلامس مشكلة الإنسان المعاصر، فيقدم قراءة جديدة لمشكلته الكبرى وسؤاله الأهم: ما هو أصل الوجود ومصدره؟ سؤال شغل التفكير الإنساني في مختلف العصور، وتكفلت الرسالات التوحيدية بإثبات المصدر الغيبي لهذا الكون وانقسم التفكير الإنساني في المقابل حول هذا الموضوع فظهرت الآراء، ونشأت التيارات، وقامت الفلسفات المتناقضة بين مادية ومثالية وعقلانية.
ووقف إنساننا المعاصر يلتمس أصل القصد، ومصدر المعنى، في زمن تسود فيه الآلة ويغيب فيه اليقين تفحص رجل الحداثة الأدلة باحثًا عن البراهين التي تروي عطشه للحقيقة المطلقة التي لا يراودها شك ولا تشوبها شائبة.
ولما كان هذا العصر عصر الاكتشافات العلمية والإبداعات التكنولوجية، خاطب الكتاب العقل المعاصر مستنيرًا بنور المعطيات العلمية الحديثة.
في الخاتمة، لا يمنحنا الكاتب يقينًا بسيطًا، بل نهجًا فكريًّا تأمّليًّا. يلوّح لنا بأن "التصميم" ليس فرضية علمية فقط، بل هو طرح يفتح أفقًا للمعرفة، يعيد إلى واجهة الوعي سؤالاً يلامس جوهر الكينونة:
هل نحن أثرُ عقلٍ متعالٍ، أم محضُ نتاج فراغٍ أعمى؟.













